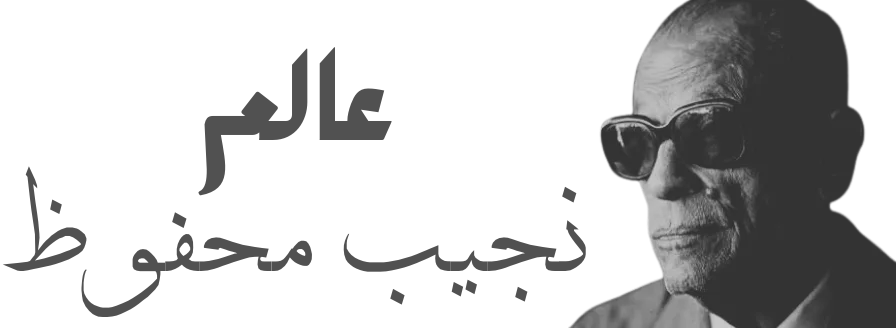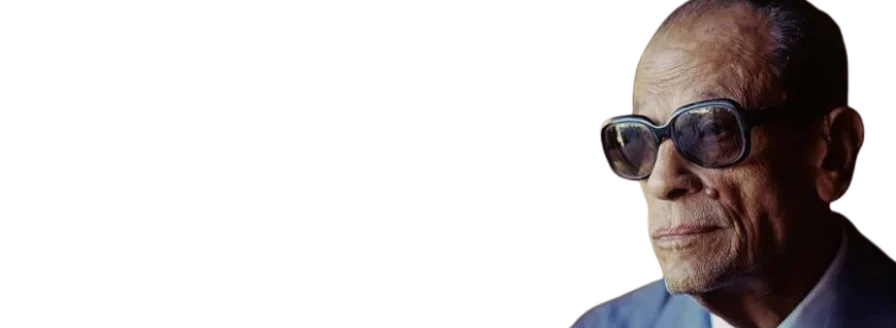رواية
حكايات حارتنا
«أستيقظُ فأجدني وحيدًا في الساحة، حتى الشمسُ توارَت وراء السور العتيق، ونسائمُ الربيع تهبط مُشبعة بأنفاس الأصيل. عليَّ أن أَمرُق من القبو إلى الحارة قبل أن يَدلهِمَّ الظلام. وأنهض مُتوثِّبًا، ولكنَّ إحساسًا خفيًّا يساورني بأنني غير وحيد، وأنني أَهِيم في مجالِ جاذبيةٍ لطيف، وأنَّ ثمة نظرةً رحيبة تستقرُّ على قلبي، فأنظرُ ناحيةَ التكيَّة.»
هل فكَّرتَ يومًا في الطفولةِ التي عاشها «نجيب محفوظ»؛ الطفولةِ التي كانت المحطة البِكر في حياة كاتبنا، والتي مَنحَته من اتِّساع الخيال وجمال الصورة ما مَكَّنه من سرد آلاف القصص والشخصيات التي استلهمها من حارتِه التي عاش فيها، وسكَّانِها الذين تَجسَّدوا أمام عينَيه؟ في هذا الكتاب البديع نرى «نجيب محفوظ» الطفل، ونستشعر نظرتَه الطفولية للحياة؛ تلك النظرةَ البريئة التي جعلَته يَتلمَّس جمال الأشياء، ويَمنحها الخلود بكلماته الدافئة، وتعبيراته الساحرة، فيَسرد حكاياتٍ كثيرةً عن حارته التي كانت البطلَ الأول في حياته، ومُلهِمتَه التي ظلَّ وفيًّا لها طَوال عمره؛ فبدأها بالحديث عن التكيَّة، ثم تَحدَّث عن «أم زكي»، و«زوجة المأمور»، و«بنات القيرواني»، و«مشهد كسوف الشمس». وتَتوالى الحكايات المحفوظية الخلَّابة التي يختمها بالحكاية رقم «٧٨»، التي يَتجلَّى فيها ولَع «محفوظ» بالتكيَّة وشيخها.